الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنا نعيذك بالله تعالى من الردة عن الدِّين الحق، ونسأله تعالى أن يشرح للحق صدرك، ويفتح له قلبك، وأن يلهمك رشدك، وأن يعيذك من شر نفسك.
وأما استحقاق كل كافر لدخول النار، فأمر منطقي، لا ينكره العقل، وحكم شرعي ثابت بالنقل، فمن ضيع أصل دينه، وكفر بالله تعالى، أو أشرك به، فكيف يحكم له بدخول الجنة؟! وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء، كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. رواه البخاري، ومسلم. وقد سبق لنا بيان كون الكفر والشرك محبطًا للعمل، موجبًا للخلود في النار، وراجعي في ذلك الفتوى: 219898.
ويستثنى من هذا الحكم من لم تقم عليه الحجة التي لا يعذب الله أحدًا إلا بعد قيامها، وهي لا تقوم على غير المسلم إلا إذا بلغته دعوة الإسلام بطريقة يتمكن من فهمها، لا يحول بينه وبينها حائل، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأشخاص، كما سبق لنا بيانه في الفتوى: 311626، وما أحيل عليه فيها.
وأما تعريف الإسلام بالسلام، فلا يصح لا لغة، ولا شرعًا، وإنما معناه الاستسلام لله رب العالمين؛ إيمانًا به، وخضوعًا لأمره، كما يدل عليه قوله تعالى: بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {البقرة:112}، وقوله: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا {النساء:125}.
قال ابن كثير في قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ {النساء:125}: أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيمانًا واحتسابًا {وهو محسن} أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له، وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي: يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعًا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمن فقد عمله أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقًا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالًّا جاهلًا، ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين. اهـ.
وقال الخازن في تفسيره: معنى {أسلم وجهه لله} أخلص في دينه لله، وقيل: أخلص عبادته لله، وقيل خضع، وتواضع لله؛ لأن أصل الإسلام الاستسلام، وهو الخضوع، وإنما خص الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف الأعضاء، وإذا جاد الإنسان بوضع وجهه على الأرض في السجود، فقد جاد بجميع أعضائه. اهـ.
وعلى هذا نص أهل اللغة، قال الصاحب بن عباد في المحيط في اللغة: الإسلام: الاستسلام لأمر الله، والانقياد لطاعته، ويقولون: سلمنا لله ربنا: أي استسلمنا له، وأسلمنا، والسلم ـ أيضًا ـ: الإسلام، والمسلم: المستسلم. اهـ.
وقال الأزهري في تهذيب اللغة: الإسلام: إظهار الخضوع، والقبول لما أتى به الرسول عليه السلام. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة: لماذا سمي الدين الإسلامي بالإسلام؟
فأجابت: لأن من دخل فيه أسلم وجهه لله، واستسلم، وانقاد لكل ما جاء عن الله، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، قال تعالى: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} إلى قوله: {إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين}، وقال: {بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه}. اهـ.
وأما قول السائلة: (لماذا لم يقل "ومن يتّبع" بدل {من يبتغي}) فالله أعلم بسر ذلك، ولكن كل من اللفظين سيؤدي إلى النتيجة نفسها، وهو أن كل دين غير الإسلام فلن يقبل من صاحبه، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ {آل عمران:19}: إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي سد جميع الطرق إليه، إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثته محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته، فليس بمتقبل، كما قال تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} [آل عمران:85] وقال في هذه الآية مخبرًا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: {إن الدين عند الله الإسلام}. اهـ.
وقد جاء ما يؤيد هذا المعنى بلفظ الاتباع، كما قال تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا {النساء:115}، وقال عز وجل: قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ {الأعراف:156-157}.
فهذا هو جواب إشكالك الأول، ونحن من عادتنا أن لا نجيب من الأسئلة المتعددة إلا عن السؤال الأول، ونطلب من السائل إعادة إرسال بقية أسئلته كل على حدته، ولكن نستثني سؤالك هذا لما رأيناه من حيرة قد تفسد عليك دينك، وتوقعك في ما لا تحمد عقباه.
فبالنسبة لما يتعلق بقضية المرأة، ومكانتها، وتكريم الإسلام لها، ومقارنة ذلك بحالها في الجاهلية، وعند أصحاب الملل الأخرى، فقد سبق لنا تناوله في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية: 227656، 3661، 16032، وراجعي ما أحيل عليه في الفتوى: 228415.
وننبه هنا على خطأ السائلة فيما نسبته للإسلام من الأحكام، والأوصاف المسيئة للمرأة، في قولها (رجس من عمل الشيطان، وعار، وهمّ على أهلها، وحرم عليها العمل، مأمور بحبسها في المنزل، مأمورة بالسجود للزوج، ومن سكان النار)، فكل هذا لا يصح لصقه بالإسلام، وإنما هو فهم مغلوط من السائلة، ستجد بيانه فيما أحيلت عليه من الفتاوى.
وأما قصة أم المؤمنين سودة بنت زمعة -رضي الله عنها- فخلاصتها أنها وهبت يومها لعائشة لما طعنت في السن، وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها رغبته في طلاقها، أو أنه طلقها فعلًا، وقد سبق لنا إجمال ذلك في الفتوى: 227743.
والصحيح من الروايات في ذلك يدل على أنها فعلت ذلك رغبة منها في فعل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبًا لرضاه، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة من زوجاته يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
وقالت أيضًا: ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. رواه مسلم.
وقالت عائشة أيضًا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: نقول في ذلك: أنزل الله تعالى، وفي أشباهها: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا..} رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين، وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة) وقال: قد روي في حديث سبب خشية سودة أن يطلقها صلى الله عليه وسلم، وهو فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن أبي الزناد بإسناده المتقدم عن عائشة قالت: كانت سودة بنت زمعة قد أسنت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، وقد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يستكثر مني، فخافت أن يفارقها، وضنت بمكانها عنده، فقالت: يا رسول الله، يومي الذي يصيبني لعائشة، وأنت منه في حل، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نزلت: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا} الآية. لكن في إسناده شيخه محمد بن عمر، وهو الواقدي، وهو كذاب، ثم روي من طريق القاسم بن أبي بزة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى سودة بطلاقها... الحديث، ونحوه من رواية الواقدي عن التيمي مرسلًا، وفيه أنها قالت: يا رسول الله، ما بي حب الرجال، ولكن أحب أن أبعث في أزواجك، فأرجعني... ونحوه عن معمر معضلًا. وهذا مرسل، أو معضل، فإن القاسم هذا تابعي صغير روى عن أبي الطفيل، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وغيرهم. وهو مع إرساله منكر؛ لأن الروايات المتقدمة صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلقها، وهذا يقول: بعث إلى سودة بطلاقها.
فإن قيل: لماذا خشيت سودة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم إياها؟
فأقول: لا بد أن تكون قد شعرت بأنها قد قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في القيام ببعض حقوقه، فخشيت ذلك، ولكني لم أجد نصًّا يوضح السبب سوى رواية الواقدي المتقدمة التي أشارت إلى ضعفها من الناحية الجنسية، ولكن الواقدي متهم كما سبق، ويحتمل عندي أن السبب ضيق خُلقها، وحدة طبعها الحامل على شدة الغيرة على ضراتها، فقد أخرج مسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال: ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حِدّة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة... اهـ.
وهنا نذكٍّر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج سودة بعد وفاة خديجة -رضي الله عنهما-، وكانت أرملة كبيرة في السن عندها خمسة أولاد، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها إلا بعد ثلاث سنوات من زواجها بعد هجرته للمدينة، ولم تهب هي يومها لعائشة إلا بعد أن طعنت في السن، ولم يكن لها في الرجال من حاجة، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا مراعاة لسن عائشة، وحالها، فقد كانت حديثة السن، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا، بخلاف سائر زوجاته، فقد كن ثيبات، ومات عنها صلى الله عليه وسلم ولم يكن لها إلا ثمان عشرة سنة، وهي أكثر من حملت عنه العلم من زوجاته، وأبلغته لأمته بعد ذلك.
وأما ما يتعلق بالحور العين، وذكر المتقين دون المتقيات في القرآن، فراجعي فيه الفتويين التالية: 199939، 66801.
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 
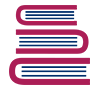
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات