الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشرح صدرك، ويلهمك رشدك، ويعيذك من شر نفسك. فما هكذا يستقبل المؤمن ما قد يعرض له من شبهات. فالمؤمن الحق عنده من الأصول والضوابط، ما تقف معه كل شبهة عند حدها، فلا تعدو قدرها، حتى ولو لم يجد لها من الجواب المفهم ما يزيل أصلها ويحل عقدها.
فالإيمان الحق له من الأدلة القاطعة ما لا يحصى، ولا يصح أن تزلزل هذا القواطع لمجرد إشكال قد يغيب جوابه عن العبد.
والمنهج الصحيح عندئذ أن يرد المتشابه إلى المحكم، ويستعين بالله تعالى ويلجأ إليه، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ * رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران: 7-8].
فالشبهة تبقى شبهة! ولا تبلغ أن تكون عقدية تزعزع اعتقادا راسخا، أو تزلزل أصل الإيمان الذي هو محبة الله تعالى!
ولذلك فإن المؤمن إن شوش عليه شيء من الشبهات، دفعه أولا بإيمانه الراسخ، ثم بعد ذلك بالتعلم والسؤال.
وما دقَّ من مسائل القضاء والقدر هي من هذا الباب، لها أصل محكم، وفروع مشتبهة.
فالأصل هو الإيمان بتمام علم الله وحكمته، وعدله ورحمته، ولطفه وقدرته.
ومن المشتبه ما أشكل على السائلة، وهو الجمع بين إثبات قدر الله ونفوذ مشيئته، وبين إثبات اختيار العبد وكسبه لفعله.
وهذا شيء لا تحتمله أكثر العقول، ولذلك كان موضع ابتلاء وتمحيص وتمييز بين الناس، فمنهم من يتمسك بالأصل المحكم فيسلم، ومنهم من يتيه مع الفرع ويضيع الأصل فيهلك.
وذلك أن في القدر سراً لله تعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكفي العاقل أن يعلم أن الله عز وجل عليم حكيم رحيم، بهرت الألباب حكمته، ووسعت كل شيء رحمته، وأحاط بكل شيء علمه، وأحصاه لوحه وقلمه، وأن لله تعالى في قدره سرا مصونا، وعلما مخزونا، احترز به دون جميع خلقه، واستأثر به على جميع بريته ... وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق. اهـ.
وخلاصة الأمر أن أننا مع إثباتنا لقدر الله تعالى، فإننا نثبت للعبد اختيارا يصح معه تكليفه ومجازاته، ولا يخرج عن قضاء الله تعالى وقدره! وهذا يوافق الواقع المحسوس في تمييز الناس بين الفعل الاختياري، كتحرك الإنسان لفعل يريد، وبين الفعل الاضطراري كحركة المرتعش والمحموم. والتكليف والمجازاة إنما تكون على الأول دون الثاني.
ولوضوح هذا الفرق لا تكاد تجد أحدا يرضى ممن ظلمه أو تعدى عليه، أو سلبه حقه أن يحتج عليه بالقدر السابق، بل يقول: هذا فعلك باختيارك ومشيئتك، كما يدل عليه العقل والحس.
وقد سبق لنا بيان بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمعايب، وراجع في ذلك الفتاوى: 49314، 300247، 57828، 242914.
ولذلك فنحن لا نقول: إن الإنسان مخير، بإطلاق، كما لا نقول: إنه مسير، بإطلاق، بل نقول: إنه مخير من وجه، مسير من وجه، أو نلخص ذلك فنقول: إنه ميسر لما خلق له. وراجعي في ذلك ما أحيل عليه في الفتويين: 234691، 151961.
والأمر الذي لا بد من لفت النظر إليه أن القدر من الغيب الذي لا يعلمه الإنسان، ولا يصح أن يترك المرء ما أمر به ويتكل على كتابه الأول، ويضيع نفسه محتجا بغيب لا يعلمه. بل الصواب أن يجتهد الإنسان في طاعة الله ويتجنب معصيته، ويرجو ثوابه ويخاف عقابه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. فقالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى [الليل: 5 - 10]. رواه البخاري ومسلم.
وراجعي في معناه الفتوى: 353533. وراجعي للأهمية، الفتوى: 312490.
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

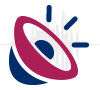
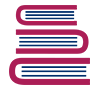
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات