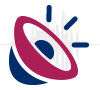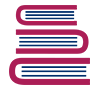السؤال
قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ( وإذا مرضت فهو يشفين) ومعلوم بأن القدر خيره وشره من الله. فلماذا قال إبراهيم عليه السلام ذلك فإن كان المعنى وإذا مرضت بسبب ذنبي فهو يشفين بفضله والكل من قدره، فالمرض بسبب الذنب والشفاء بسبب فضله وإحسانه, فهل هذا يدل على أن إبراهيم يقع ببعض الذنوب التي تستوجب بعض الأمراض لتكفيرها عنه أم قال إبراهيم ذلك تأدبا ؟ فإن كان تأدبا فهل هناك بعض أفعال الله لا تذكر تأدبا وهو الذي له الأسماء الحسنى والخير كله بيديه والشر ليس إليه؟ وهل إبراهيم عليه السلام معصوم من الذنوب مطلقا؟ وما رأيكم فيمن يقول بأن كل مصيبة تصيب العبد المكلف فهي بسبب ذنب ولو كان نبيا وكونه بسبب ذنب فهي لا تنافي أن تكون لأجل حكم أخرى كرفعة الدرجات ونحوها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم المقطوع به أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأنه لا تكون حركة ولا سكنة إلا بإذنه ومشيئته، ولا يوجد في الكون إلا ما قدره وقضاه، فالشر مخلوق لله تعالى كما قال تعالى: الله خالق كل شيء {الزمر:62}. لكن الشر ليس إلى الله تعالى فهو ليس من أفعاله وإن كان من مفعولاته، وذلك أن الله إنما خلق الشر لحكم بالغة تترتب على وجوده، فخلقه وإيجاده له ليس شرا وإن كان هو في نفسه شرا. ولذا لا يضاف الشر إلى الله تعالى، بل إما أن يدخل في العموم كقوله: الله خالق كل شيء {الزمر:62}. أو يضاف إلى سببه كقوله: من شر ما خلق {الفلق:2}. أو يحذف فاعله كقول مؤمني الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض {الجن:10}. ومن الثاني قول الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. {سورة الشعراء:80}
قال شيخ الإسلام: والله تعالى وإن كان خالقا لكل شيء فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا، كما قال: {الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين} [سورة السجدة: 7] وقال: {صنع الله الذي أتقن كل شيء} [سورة النمل: 88] فلهذا لا يضاف إليه الشر مفردا، بل إما أن يدخل في العموم، وإما أن يضاف إلى السبب، وإما أن يحذف فاعله. فالأول: كقول [الله تعالى]: {الله خالق كل شيء} [سورة الزمر: 62] والثاني: كقوله: {قل أعوذ برب الفلق - من شر ما خلق} [سورة الفلق: 1، 2] والثالث كقوله فيما حكاه عن الجن: {وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا} [سورة الجن: 10] وقد قال في أم القرآن: {اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [سورة الفاتحة: 6، 7] فذكر أنه فاعل النعمة، وحذف فاعل الغضب، وأضاف الضلال إليهم. وقال الخليل [عليه السلام] {وإذا مرضت فهو يشفين} [سورة الشعراء: 80] ، ولهذا كان لله الأسماء الحسنى، فسمى نفسه بالأسماء الحسنى المقتضية للخير. وإنما يذكر الشر في المفعولات، كقوله: {اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم} [سورة المائدة: 98]. انتهى. وهذا من تمام الأدب مع الله تعالى في الخطاب بحيث لا يضاف إليه مفردا إلا أشرف قسمي أفعاله سبحانه.
قال ابن القيم رحمه الله: وأما المسألة الخامسة وهي أنه قال: {الذين أنعمت عليهم} ولم يقل المنعم عليهم كما قال المغضوب عليهم فجوابها وجواب المسألة السادسة واحد، وفيه فوائد عديدة: إحداها أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن الكريم وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول، فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف وبني الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب، وإضافته إلى الله تعالى أشرف قسمي أفعاله فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلها، ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: {المغضوب عليهم} وقال في الإحسان الذين أنعمت عليهم. ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: {الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين} فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي إلى الله تعالى ولما جاء إلى ذكر المرض قال وإذا مرضت ولم يقل أمرضني، وقال فهو يشفين ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: {وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا} فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول. ومنه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة: {فأردت أن أعيبها} فأضاف العيب إلى نفسه وقال في الغلامين: {فأراد ربك أن يبلغا أشدهما} ومنه قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}. فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. لأن في ذكر الرفث ما يحسن منه أن لا يقترن بالتصريح بالفاعل. انتهى.
فإذا تحرر لك هذا المقام وعلمت وجه عدم إضافة الشر مفردا إلى الله تعالى مع كونه مخلوقا له، فاعلم أن العلماء اختلفوا في عصمة الرسل عليهم السلام، فذهب كثير منهم إلى أنهم معصومون من تعمد الذنب مطلقا، وأن ما نسب إليهم من ذلك فهو من الخطأ والنسيان أو فعل خلاف الأولى مما يقال في مثله: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأنبياء تجوز عليهم صغائر الذنوب ولكنهم لا يقرون عليها، فهم معصومون من الإقرار على الذنوب بل يبادرون بالتوبة النصوح وتكون التوبة في حقهم كمالا ويكونون بعدها خيرا وأفضل مما كانوا قبلها، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله: ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على الذنوب وأن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله فإنه يحب التوابين وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأن ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال النهاية بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب. وأما غيرهم فلا تجب له العصمة. انتهى.
وعلى كل تقدير فما يصيب الأنبياء من المصائب والبلايا ليس لذنب ارتكبوه فإنهم إما معصومون من تعمد الذنوب مطلقا وإما من الإقرار عليها، ولكن تكون المصائب في حقهم لحكم عظيمة منها رفع درجاتهم، ومنها أن يكونوا أسوة لمن بعدهم من أممهم، ومنها ألا يغلوا فيهم أتباعهم فيخلعوا عليهم ما هو من خصائص الألوهية.
قال شيخ الإسلام: وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. انتهى.
وهذه المسألة فيها مناقشات تطول جدا.
والله أعلم.

 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى