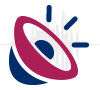السؤال
إذا كان من رجحت حسناته على سيئاته يوم القيامة دخل الجنة، ولم يعذب، فقد يأتي بعض الناس، ويحسب لنفسه حسناته وسيئاته في الدنيا، ويقول -مثلا-: اليوم أشرب الخمر، ثم أتصدق، وغدا أزني ثم أعتمر ... وهكذا. ويظل هكذا معتمدا على أن حسناته ستكون أكثر من سيئاته، فما هو الرد على هذه الشبهة -بارك الله فيكم-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام من أقبح الغرور، وأعظم الجهل بالله، وشرعه، فما يدري قائل هذا القول المنكر أن الله يتقبل منه حسناته التي يعملها؟! وما يؤمنه أن يطلع الله عليه وهو على بعض ذنوبه فيمقته، ويسقط من عينه -سبحانه-، ويخذله، ثم لا يوفقه لطاعة، وقد قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. فلا يزال العبد يرتكب السيئات، وتملي له نفسه الأمارة بالسوء الانهماك في المعاصي حتى لا يستطيع الانفكاك عنها، ولا الخلاص منها، فالمؤمن الموفق يعمل بالطاعات، ويخاف ألا تقبل، ويخاف أن يؤتى من قبل نفسه، وأن يخذله الله، ويمقته بسبب ذنوبه؛ خذ هذا الخبر من السير للذهبي، قال -رحمه الله-: قال زهير بن عباد الرؤاسي: عن أبي كبير البصري، قالت أم محمد بن كعب القرظي له: يا بني، لولا أني أعرفك طيبا صغيرا، وكبيرا، لقلت: إنك أذنبت ذنبا موبقا؛ لما أراك تصنع بنفسك. قال: يا أماه، وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي، فمقتني، وقال: اذهب، لا أغفر لك. ونظير هذا في أخبارهم كثير.
ثم إن ما يجهله العبد من ذنوبه كثير، وما يظنه صغيرا وهو كبير كثير، وما يأتي به من الطاعات فأكثره مدخول، قد يخالطه الرياء، أو العجب، مع التقصير في القيام به على وجهه؛ قال ابن القيم -رحمه الله-: فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم، والعمل، فالمعصية في حقه أشد، وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب، ولا يعلمه العبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي، وهزلي، وخطأي، وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه، وجله، خطأه، وعمده، سره، وعلانيته، أوله، وآخره. فهذا التعميم، وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه، وما لم يعلمه. انتهى.
فكيف يظن هذا الجاهل المغرور أنه يقدر أن يعد سيئاته في الدنيا حتى يفعل بإزائها حسنات، ثم يزيد عليها شيئا فينجو، وهو إن فعل الطاعة فهو على خطر ألا تقبل لما يخالطها من الآفة، وقد كان خوفهم، وهمهم لقبول العمل أشد من همهم لنفس العمل، حتى جاء عن بعضهم أنه قال: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين ما أحببت البقاء في هذه الدنيا؛ لأني سمعت الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد قال بعض السلف: إن في طاعاتنا من الآفة ما لا نحتاج معه إلى ارتكاب سيئة.
قال ابن رجب: كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها، كما يستغفر المذنب من ذنبه، إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم، فكيف حال المسيئين مثلنا في عباداتهم؟! انتهى.
فعلى المسلم أن يترك المعاصي صغيرها، والكبير، وأن يفعل ما قدر عليه من الطاعات، ثم ليكن بعد ذلك كله على حذر.
وأما نحو هذا الكلام الساقط المذكور: فهو من غرور الشيطان الذي حذرناه الله بمثل قوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور {فاطر:5}.
والله أعلم.

 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى