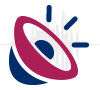السؤال
يقول الله عز وجل في القرآن: (كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء). ما معنى (يضل من يشاء)؟ وما هي صور إضلال الله للعبد؟ وهل يعني إضلال الله للعبد مثلا أن ييسر له الله المعصية، أو أن الله يجعله يقتل أو يزني، أو مثلا يحثه الله على المعاصي؟ أم كيف يضله؟ وهل يصح أن نقول: إن الله جعل فلانا يعصيه، أو أن الله يسر له المعصية، أو دفعه لفعلها -أقصد بذلك الضالين-؟
أرجو الجواب على السؤالين، وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى، وأنه سبحانه خالق أفعال العباد، وأنه هو الذي جعل المهتدي مهتديا وجعل الضال ضالا، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه، فمعنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء: أنه يجعل من يشاء مهتديا، ويجعل من يشاء ضالا، وليس معنى هذا نفي مسؤولية العبد عن أفعاله، بل العبد قد ضل بمشيئته واختياره وإرادته، ولكنه لم يفعل ذلك إلا بمشيئة الله واختياره، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين {التكوير:29،28}.
قال ابن القيم -رحمه الله-: وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي؛ فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. انتهى.
فإذا علمت معنى إضلال الله للعبد، فاعلم أن هذا الإضلال يكون بحجب الله توفيقه عن العبد، وتخليته بينه وبين تلك الذنوب، فإذا خلى الله العبد ونفسه الظالمة الجاهلة أوجب له ذلك أن يختار الضلال على الهدى، فيزيده الله ضلالا على ضلاله باختياره ما يسخطه سبحانه، ولله في ذلك كله الحكمة البالغة، ففعل الله كله خير، ولا يتطرق الشر إليه بوجه من الوجوه، وإنما الشر في فعل العبد وهو منسوب إليه؛ قال ابن القيم: فإذا بقيت النفس على عدم كمالها الأصلي، وهي متحركة بالذات لم تخلق ساكنة؛ تحركت في أسباب مضارتها وألمها، فتعاقب بخلق أمور وجودية، يريد الله سبحانه تكوينها عدلا منه في هذه النفس وعقوبة لها، وذلك خير من جهة كونه عدلا وحكمة وعبرة وإن كان شرا بالإضافة إلى المعذب والمعاقب، فلم يخلق الله سبحانه شرا مطلقا، بل الذي خلقه من ذلك خير في نفسه وحكمة وعدل، وهو شر نسبي إضافي في حق من أصابه، كما إذا أنزل المطر والثلج والرياح، وأطلع الشمس، كانت هذه خيرات في نفسها وحكم ومصالح، وإن كانت شرا نسبيا إضافيا في حق من تضرر بها.
وبالجملة: فالكلمة الجامعة لهذا هي الكلمة التي أثنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه حيث يقول: "والشر ليس إليك". فالشر لا يضاف إلى من الخير بيديه، وإنما ينسب إلى المخلوق، كقوله تعالى: {قل أعوذ برب الفلق - من شر ما خلق} [الفلق: 1 - 2] فأمره أن يستعيذ به من الشر الذي في المخلوق، فهو الذي يعيذ منه وينجي منه، وإذا أخلى العبد قلبه من محبته والإنابة إليه، وطلب مرضاته، وأخلى لسانه من ذكره والثناء عليه، وجوارحه من شكره وطاعته، فلم يرد من نفسه ذلك ونسي ربه، لم يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك ونسيه كما نسيه، وقطع الإمداد الواصل إليه منه كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده، قال تعالى: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} [الحج: 37]. فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه، وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعينه في قوله تعالى: {ونذرهم في طغيانهم يعمهون} [الأنعام: 110] أي: نخلي بينهم وبين نفوسهم التي ليس لهم منها إلا الظلم والجهل، وقال تعالى: {ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم} [الحشر: 19]، وقال تعالى: {أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم} [المائدة: 41] فعدم إرادته تطهيرهم، وتخليته بينهم وبين نفوسهم -أوجب لهم من الشر ما أوجبه. انتهى.
فإذا فهمت هذا القدر؛ تبين لك معنى إضلال الله للعبد، وكيفية حصوله، وأنه لا مانع من نسبة الإضلال إلى الله، والإخبار بأنه هو الذي جعل فلانا يفعل كذا، لكن مع اعتقاد أن هذا العبد مسؤول عن فعله بما خلق الله له من الإرادة والمشيئة والاختيار، وأن فعل الله لهذا الإضلال خير محض، وإنما ينسب الشر إلى العبد، وأن لله تعالى حكمته البالغة في هدايته من هداه وإضلاله من أضله، وهذه الجملة تحتمل بسطا كثيرا لا يتسع له هذا المقام، ففي هذه الجملة كفاية -إن شاء الله-.
والله أعلم.

 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى