السؤال
حد الزاني المُحصن هو الرجم حتى الموت.
من هنا أريد توضيح مسألة تأتي إلى ذهني في بعض الأحيان ولا أجد لها إجابة شافية:
شخصان محصنان زنى كل منها، أحدهما تم إقامة حد الزنى عليه، فمات بمعصيته ولم يتبق لديه وقت للرجوع إلى الله. والشخص الآخر لم يُقم عليه حد الزنى، فبقي لديه وقت ليرجع فيه إلى الله لعل الله يَغفِر له.
أعلم وأوقن أن الله عادل ورحيم، ولكن لا أستطيع إيجاد العدل فيما ذكرته لعدم إلمامي بكل شيء في الدين، ولأن لدي من المعرفة الكافية!
فأرجو التوضيح.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على المسلم الاعتقاد بأن الله تعالى عدل لا يظلم أحدًا من خلقه مثقال ذرة، ولا يقع في أفعاله -سبحانه- ظلم أبدًا، فقد قال -سبحانه وتعالى-: إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ {النساء:40}، وقال -سبحانه وتعالى-: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ {فصلت:46}، وقال تعالى: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا {الكهف:49}. وفي صحيح مسلم عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيما روى عن الله -تبارك وتعالى- أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا ... الحديث.
والعدل ليس هو التسوية بين الخلق في كل شيء! كلا، بل العدل هو وضع الشيء في موضعه اللائق به، كما أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ قال ابن القيم: والصواب أن العدل وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها وإنزالها منازلها، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد تسمى سبحانه بالحكم العدل. اهـ.
وقال أيضًا: وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو سبحانه حكم عدل، لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة، وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يساوي بين مختلفين، ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة، ويضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة، ولا يعاقب أهل البر والتقوى. اهـ.
فليس في كون أحد الزانين أقيم عليه الحد والآخر فسح في أجله ولم يقم عليه الحد ظلم لأحدهما، فتفاوت المقادير بين العباد ليس ظلمًا أبدًا، وإلا فيلزم على ذلك أن العدل لا يتحقق إلا إذا تساوى الخلق جميعهم في كل ما يقدره الله عليهم! وهذا من أبطل الباطل.
ثم إن قولك عن الأول: (فمات بمعصيته ولم يتبق لديه وقت للرجوع إلى الله) خطأ، فما الذي يمنعه من التوبة والرجوع إلى الله، بل إذا علم أنه سيحد في الغد -مثلًا- كان هذا أدعى لتوبته ورجوعه، وربما لقي الله بلا ذنب، مع ما يستفيده أيضًا من تطهير الحد، كما في حديث الجهنية التي زنت: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟!) رواه مسلم.
وإذا كان المرء مقرًّا أن وقوع الشخصين في معصية الزنا ليس ظلما لهما -مع أنه بتقدير الله وقضائه عليهما-، فكذلك الشأن فيما يقضيه الله عليهما بعد ذلك من إقامة حد أو عدمه، أو غير ذلك من سائر المقادير.
ومما يبين أن العقول تقصر وتتفاوت في التعاطي مع ما يتعلق بحكمة الله وعدله في قضائه: أن قولك (شخصان محصنان زنى كل منها، أحدهما تم إقامة حد الزنى عليه، فمات بمعصيته ولم يتبق لديه وقت للرجوع إلى الله, والشخص الآخر لم يُقم عليه حد الزنى، فبقي لديه وقت ليرجع فيها إلى الله لعل الله يَغفِر له. أعلم وأوقن أن الله عادل ورحيم. ولكن لا استطيع إيجاد العدل فيما ذكرته لعدم إلمامي بكل شيء في الدين، ولأن لدي من المعرفة الكافية!). يظهر منه أنه انقدح في نفسك أن العدل لم يتحقق في هذا الأمر؛ لأن الشخص المحدود قد فُضِّل عليه من لم يقم عليه الحد بإمهاله وأنه قد يجد وقتًا للتوبة لذلك، بينما لغيرك أن يرى التفضيل في عكس ذلك، فيقول: إن من أقيم عليه الحد هو الذي فُضِّل، فإن الحدود بمجردها كفارات للذنوب التي أقيمت بسببها، ولو دون توبة؛ ففي صحيحَي البخاري، ومسلم، عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، قال: كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- في مجلس، فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا -وقرأ هذه الآية كلها- فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه» .قال القاضي عياض: أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحدود كفارة أخذًا بهذا الحديث. اهـ. من إكمال المعلم. بينما الذي لم يقم عليه الحد لم ينل ذلك، وقد لا يتوب مثلًا وإن أُمهل.
فالحاصل: أن التفاوت بين الخلق في المقادير ليس ظلمًا أبدًا، وأن تفضيل بعض العباد على بعض لا ينافي عدل الله -جل وعلا-، وأنه لا سبيل لمخلوق إلى الإحاطة بحكمة الله -جل وعلا- فيما يخلق ويقدر، فإن القدر سر الله الذي لم يحط به علمًا سواه، قال الإمام الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرج الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا أو فكرًا أو وسوسة، فإنه تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه؛ كما قال -عز وجل-: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اهـ.
وإنما على العبد التسليم والإذعان بأن الله -جل وعلا- حكيم، لا يقضي إلا ما له فيه أتم الحكمة، وله عليه أوفى الحمد، وأن أفعاله سبحانه دائرة بين العدل والفضل، وهو سبحانه لا يظلم أحدًا.
وللمزيد في هذا الباب راجع الفتاوى التالية أرقامها: 172571، 31767، 53994، 2855، 137631.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

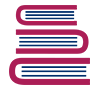
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات