السؤال
ما قيد العفو؟ وهل أعفو مطلقًا عن أي ظلم دون شروط؟ وهل هذا إحسان أم ذلّ؟ وهل هذا أعلى منازل الإحسان؟ وإن كان الظلم متكررًا، ولا يزال، فهل يجب أن أصبر، وأعفو، وأتنازل عن حقّي دومًا؟ وهل في ذلك مرضاة الله تعالى؟ وهل من الأفضل أن لا أنتصر لنفسي أبدًا، وأن أقتصر على الدعاء؟ علمًا أني عادة لا أقتصّ، وأكتفي بالصمت، وليس لي إلا الدعاء، وبعض الأنبياء دعوا على بعض الظالمين -وهم مَنْ هم-، فهل توجد حالات يستحب فيها الدعاء على الظالم، أم إن ذلك جائز دومًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعفو إنما يستحب إذا تضمّن مصلحة.
وأما إذا كان ترك العفو أصلح؛ فتركه أولى؛ فلا يستحبّ العفو مطلقًا، وإنما يستحبّ حيث كان أصلح، فمن عرف بالشرّ والفساد، وكان العفو يزيده تماديًا في شرّه؛ فلا يستحبّ العفو عنه.
ثم إن العفو إنما يحسُن ويجمُل مع القدرة، لا مع العجز عن الانتصار.
وهو إنما يستحبّ في حقّ العبد، لا في حقوق الله تعالى، وهذه المعاني قد بيّناها تفصيلًا في الفتوى: 391813.
وبمراجعتها يتّضح لك جواب ما سألت عنه، وأن العفو لا يستحبّ بإطلاق، وليس هو الأفضل على كل حال، فمن كان لا يرتدع إلا بالانتصار منه؛ سواء بالدعاء عليه، أم أخذ الحق بالطريق المشروع؛ فالانتصار حينئذ هو الأولى.
والحاصل: أن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد وتعطيلها، فحيث كان العفو أصلح؛ كان مأمورًا به مندوبًا إليه، وحيث لم يكن كذلك؛ لم يكن مأمورًا به.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

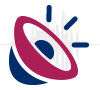
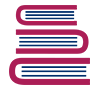
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات