
لم تُعرف معصية في تاريخ البشرية أقبح من فعلة قوم لوط، ولذا لم تعرف أيضا عقوبة ربانية في تاريخ الأمم أعظم من عقوبتهم.. ذلك أنها شذوذ عن الفطرة، وخروج عن مألوف طبيعة الخلقة، ومصادمة لمواطن الحكمة، وتحد صارخ لمقاصد الوجود.
والحضارة الجديدة هي أحق الحضارات بأن تسمى "حضارة القذارة"، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان؛ لأنها جمعت في طياتها كل قذارة في كل حضارة سبقتها، وأضافت إلى ذلك قذارات جديدة أبدعها الفكر المتحضر والتقدم العلمي الذي سخر كل التسخير لتحقيق رغبات الإنسان ولذة الجسد، وإن كانت خارجة عن كل مألوف أو مقبول.
هذه الحضارة تريد مرة أخرى أن تعيد إلى الناس وتصَدِّر إلى الوجود الفكرَ اللوطي أو العمل السّدُومي المشؤوم على البشرية، بل تسعى إلى تقنينه ودسترته، بل وأعظم من ذلك وهو فرضه على الناس كل الناس، ليس فقط منع الناس عن تجريم هذا العمل المجرم البغيض لكل نفس سوية، وكل صاحب خلقة أو فطرة طبيعية، ولكن أيضا تسعى إلى تجريم من يجرمه، ومحاكمة من يهاجمه، ومحاربة من يواجهه أو يحاربه..
والعجب العجاب أنهم لا يسعون إلى تحقيق ذلك في بلادهم فقط، بل يفرضونه فرضا على كل بلاد العالم ـ حتى على تلك الدول التي تحرم هذا الفعل القبيح أديانُها، وتخالف هذا الانحطاط مبادؤها وثقافاتها.
إن هذه الدعوات الفجة ليست هي أولى مخازي حضارة القرن الجديد والذي قبله، ولكن سبقتها مثيلات لها كانت كالمقدمات بين يديها، كحرية التعري ومحاولة شرعنته وفطرنته، وإنشاء مواطن للعراة كقرى كاملة، وشواطئ مخصوصة، ونواد لهم، وأماكن مخصوصة لتجمعاتهم.
ومن المعلوم أن هذه الحضارة جعلت الزنا حقا مكتسبا لا عقوبة عليه طالما كان بالتراضي، وهذا لم يعد غريبا على مجتمعاتهم بل هو من سمات حضارتهم وقيمهم التي يدافعون عنها بضراوة، ويعتبرونها لونا من ألوان التحضر والتقدم والحرية والمدنية، ويصدرونها إلى غيرهم، ويسمون البلاد التي لا تقبل هذا بلادا متخلفة ذات أفكار متحجرة.
لقد رضي القوم الزنا والخنا حتى صار أكثرهم لا يعرف أباه، وتطور الأمر حتى كانت نسبة المواليد الموثقة خارج نطاق الزوجية تفوق لأول مرة نسبة المواليد الشرعيين ـ على حسب وصفهم، وهذا حدث منذ عشرين سنة تقريبا في بريطانيا، ولا أظن غيرها من بلاد الغرب أحسن منها حالا. فكيف يكون الآن؟
لقد انقلبت فطر القوم وانتكست حتى أصبح من لا يمارس الفاحشة فعليا من شباب وشابات قبل زواجه وفي عمر الزهور والمراهقة يعد في قاموسهم معقدا نفسيا، يسعى والداه والمجتمع في البحث عن علاج لهذه المعضلة الكبيرة.. فاعجب إلى قوم أصبحت الطهارة عندهم قذارة، والعفة مرضا، والحياء بلاء، والشرف مرضا يحتاج إلى علاج.
إن حضارة الغرب مليئة بالقبائح والرزايا والوقائع التي يخزى لها كل عقل متزن، ويندى لها كل جبين طاهر، لا نتكلم عن كونها حضارة جسد منزوعة الروح ليس فيها قيم مثلى ولا أخلاق فضلى لأجل القيم والأخلاق، وإنما حضارة وصولية انتهازية منزوعة العلاقة بالسماء ورب السماء.. وإنما نتكلم عن الفساد والإفساد، وانتكاس الفطر، ومخالفة المبادئ والقيم، والتدني مع الشهوة إلى أحط مستوياتها وأنزل دركاتها، حتى قيل أنهم عاشروا البهائم والكلاب وأنواع الحيوانات ففاقوا قوم لوط، وكل هذا تحت مسمى الحرية وحق الإنسان في فعل ما يريد.
نحن هنا نتكلم عن سعي هذه الحضارة المرذولة إلى إعادة إنتاج اللوطية القديمة، وتحت شعار قوم لوط أيضا {أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ}(الأعراف:82).
انتكست هذه الحضارة في فطرتها، وقلبت موازين العقل، وفاقوا جرم من قبلهم حتى نادوا بأن تكون الأسرة من رجلين، أو امرأتين.. كيف هذا؟ وكيف يكون؟ وكيف يتم؟ يا للعار.
وتطور بهم الأمر حتى جعلوا ذلك حقا مشروعا يكفله القانون وترعاه الدول، وتحمي أصحابه، بل وتعطيهم جميع حقوق الأزواج الحقيقيين.
والداهية الدهياء، والفتنة العمياء والطامة الكبرى أن يقوم الآباء في الكنائس والقسس فيها والرهبان في الأديرة بعقد مثل هذه الزيجات في كنائسهم وأديرتهم ومباركتها باسم الرب وباسم الدين.
وقد كان هذا يهول بعض حسني النية، إذ كيف يقبل المُسَمَّون برجال الدين مثل هذا العفن الذي تحرمه وتحاربه جميع الأديان، ولا يقبله عقل الإنسان؟ حتى أعلن بمحاربته بعض العقلاء منهم فأطلقوا شعار (god created Adam and Eve not Adam and Steve), يعني أن الله خلق آدم وحواء، وليس آدم وستيف؛ يعني أنه خلق ذكراً وأنثى، وليس ذكرين أو أنثيين. فكيف يقبل به رجال الدين.
لكن سرعان ما تزول الدهشة حين يتذكر الإنسان أنهم أصلا أصحاب أديان باطلة وعقائد فاسدة، وأخلاق متردية، وفضائحهم قد عمت البر والبحر، وكنائسهم تشهد على مخازيهم، حتى شكا من قبيح فعالهم أهلُ ملتهم، وتكلم أناس عن تحرشاتهم وارتكابهم الزنا واللواط بأطفال وبنات ونساء صغار وكبار، ممن جاءوا يطلبون منهم الوساطة لمغفرة ذنوبهم، والصلاةَ لأن يقبل الربُّ توبتهم، فافترسوهم افتراس الذئب للأغنام، فلما فاحت روائحهم اضطرت الكنيسة للاعتراف بفضائحهم ومخازيهم، ودفع تعويضات بلغت المليارات للمتضررين وأسرهم.
إنها قلوب خاوية، ونفوس فاسدة، وأخلاق متردية، أكسبهم إياها العيشُ في هذه المجتمعات، فقبلوا بهذا المنكر العظيم، أعني الأسرة المثلية، فتلاعبوا بالدين ـ وهم أصلا كانوا حرفوه ـ وكذبوا على الله تعالى في الرضا بهذا ومباركته، وقد كانوا كذبوا عليه في نسبة الزوجة والولد إليه، وسعوا لإرضاء الناس وعدم مخالفة أهوائهم؛ محاولة منهم لجذبهم إلى دين قد هجروه فعلا بعد أن هجروه عقلا، فروضوا الدين لإرضاء الناس ولو على حساب رضا الرب الموهوم، والمصلوب المزعوم، فقبلوا بهذا المنكر العظيم بل كان منهم من يعلن أنه من هذه الطائفة. فإذا كان هذا حال رجال الكنيسة، فكيف بغيرهم؟
إنها حضارة فقدت الدين الرادع أولا، ثم فقدت الخلق المانع ثانيا، وتركت عبادة الله وذهبت إلى عبادة اللذة والهوى والشهوة، وإن كانت دنيئة قذرة، وإن كانت حيوانية بهيمية، وإن كانت مخالفة للدين والعقل والفطرة. فاستحقت بذلك أن توصف فعلا بأنها.. "حضارة القذارة".



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج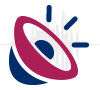 تسجيلات الحج
تسجيلات الحج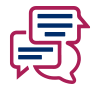 استشارات الحج
استشارات الحج

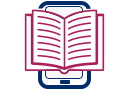












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات