السؤال
أنا طالبة في السنة الثالثة في الجامعة، انتساب. ومشكلتي هي مع المعدل. فأنا أتمنى إكمال دراستي في الماجستير في تخصصي، وهو تفسير وعلوم القرآن؛ لشرف هذا العلم وحبي له. ولحصول أجر طلب العلم الشرعي ونشره. وأخشى ألا أتخرج بالمعدل المناسب الذي يؤهلني للقبول في الماجستير(انتظام) الذي يتطلب معدلا مرتفعا جدا. فأحيانا أبذل مجهودا وأجتهد فيرتفع المعدل. وأحيانا يقل حماسي في المذاكرة والاجتهاد، فيقل المعدل. وأندم بعد ذلك وأتحسر على أني لم أبذل الجهد الكافي. فقد سبب لي ذلك قلقا كبيرا لأني أطمح لإكمال دراستي.
فهل درجاتي في الاختبار مكتوبة عند الله لا تزيد ولا تنقص ومهما ذاكرنا فالنتيجة مكتوبة، بحيث لا يمكن أن أقول لو اجتهدت كثيرا لحصلت على درجات أعلى، أو أقول هذا تكاسل وتهاون؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة الله عز وجل للمقادير ليست حجة صحيحة في ترك العبد فعل الأسباب، فقد أخرج الشيخان عن علي -رضي الله عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنة» قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة»، ثم قرأ: {فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى} [الليل: 6] الآية .
قال ابن القيم: وفيه إثبات الأسباب، وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له، وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب ومطابقتها له، فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" ومطابقته لقوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} إلى آخر الآيتين كيف انتظم الشرع، والقدر، والسبب، والمسبب. وهذا الذي أرشد إليه النبي هو الذي فطر الله عليه عباده بل الحيوان البهيم، بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك، فلو قال كل أحد إن قدر لي كذا وكذا فلا بد أن أناله، وإن لم يقدر فلا سبيل إلى نيله فلا أسعى ولا أتحرك، لعُد من السفهاء الجهال، ولم يمكنه طرد ذلك أبداً، وإن أتى به في أمر معين فهل يمكنه أن يطرد ذلك في مصالحه جميعها من طعامه، وشرابه، ولباسه، ومسكنه، وهروبه مما يضاد بقاءه وينافي مصالحه، أم يجد نفسه غير منفكة البتة عن قول النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له .اهـ من التبيان في أقسام القرآن.
بل المؤمن مأمور بالحرص على كل ما ينفعه في دينه ودنياه، وأن يتجافى عن العجز والخور؛ فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» أخرجه مسلم.
قال ابن القيم: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان: منها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصا، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به؛ فإن حرص على ما لا ينفعه، أو فعل ما ينفعه بغير حرص، فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله، ومشيئته، وتوفيقه. أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله، ولا تتم إلا بمعونته. فأمره بأن يعبده، وأن يستعين به. ثم قال: ولا تعجز. فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه، وينافي استعانته بالله. فالحريص على ما ينفعه، المستعين بالله، ضد العاجز. فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه، مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده، ومصدرها منه، ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له، فله حالتان: حالة عجز، وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو ههنا، بل هي مفتاح اللوم، والجزع، والسخط والأسف، والحزن. وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده؛ فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه، وحالة فواته؛ فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر، والكسب، والاختيار، والقيام والعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. اهـ. من شفاء العليل.
فعليك بالاستعانة بالله عز وجل في تحصيل العلم النافع، مع إخلاص النية لله وحده فيه، ولتنفضي عنك غبار العجز والتكاسل، وعليك أن تبذلي أسباب نيل العلم من الجد والاجتهاد في التحصيل، ومذاكرة العلم.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 96594 .
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

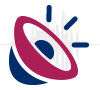
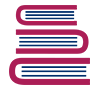
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات