السؤال
في الفتوى رقم: (44389) تقولون: "وما جنيته من عظائم وكبائر حقير في جانب عفو الله -عز وجل-".
أريد دليلا من القرآن، ومن السنة على أن الكبائر حقيرة. أنا أعلم أن عفو الله أعظم من الكبائر، لكن تحقير الكبائر والمعاصي في حق الله عظيم.
أنا أؤمن أن المعاصي سواء صغيرة كانت أو كبيرة في حق الله عظيمة جدا, وحتى محقرات الذنوب التي لا يلقي لها الناس بالًا ترمي بصاحبها إلى النار، كما في حديث محقرات الذنوب.
لكن بعد ما قرأت كلامك هذا خوف الله في قلبي قَلَّ، وأنا لا أريده أن يَقِلَّ، بل أريده يزيد.
لذلك أرجو توضيح معنى ذلك.
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نقول هذا للترغيب في المعصية، ولا لتهوين منها حاشا وكلا، وإنما نقول إن هذه الذنوب حقيرة في جنب عفو الله في حق من كان تائبا، حتى لا ييأس ويقنط من رحمة الله، لا في حق من هو مصر عليها، مستعلن بها، ودليل ذلك قول الله: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وقوله تعالى عقب ذكر الكبائر من الشرك، وقتل النفس، والزنى، ووعيد فاعلها: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان:70}.
والنصوص في هذا المعنى تستعصي على الحصر كتابا وسنة، ولا يشك مسلم في أن رحمة الله وسعت كل شيء، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكلامنا إنما هو في حق التائب لا المصر، فهذا الذي ينبغي أن يستبشر بعفو الله، ويحسن ظنه به تعالى، ويستصغر ذنوبه في جنب عفوه جل اسمه، وأما أن يصر العبد على المعصية متكلا على العفو، فهذا تَمَنٍّ، وليس رجاءً، وقد قال بعض السلف: رجاؤك رحمة من تعصيه من الخذلان. عياذا بالله من هذه الحال، وكلام من قال من السلف إن كل المعاصي كبيرة بهذا الاعتبار، وإن عليك ألا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من بارزته بها؛ هو كلام صحيح، لكنه يقال في مقام التخويف، ويخاطب به المُصِرّ المتمادي في غَيِّه.
فههنا مقامان وخطابان، خطاب لفاعل المعصية المستهين بها، فهذا يزجر، ويردع، ويبين له خطر ما هو مقيم عليه، وأنه قد يحسب هينا ما هو عند الله عظيم، وأنه لو كان ذنبه من الصغائر، فإن الصغائر يجتمعن على المرء فيهلكنه. وأما التائب الراجع إلى الله فيذكر بعفو الله تعالى، وسعة فضله، وأن رحمته وسعت كل شيء، والواعظ والناصح والفقيه يضع الدواء موضع الداء، ويخاطب كُلًّا بالخطاب اللائق به.
وإياك أن يصغر شأن المعصية في نفسك، أو تتجاسر عليها؛ فإن ذلك باب هلكة، بل متى هَمَّ الشخص بالمعصية، فعليه أن يستحضر اطلاع الله عليه، وإحاطته به، وأنه على كل شيء شهيد، ويحذر أن تسقط منزلته عند الرب تعالى، ويخذله بذنبه.
ثم إن فعل الشخص المعصية، فعليه أن يرجع، ويتوب، ويبادر بالرجوع إلى الله تعالى، غير مستعظم لمعصيته بجنب عفوه تعالى، فيجمع في طريق سيره إلى ربه بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ {الحجر:49، 50}.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

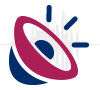
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات